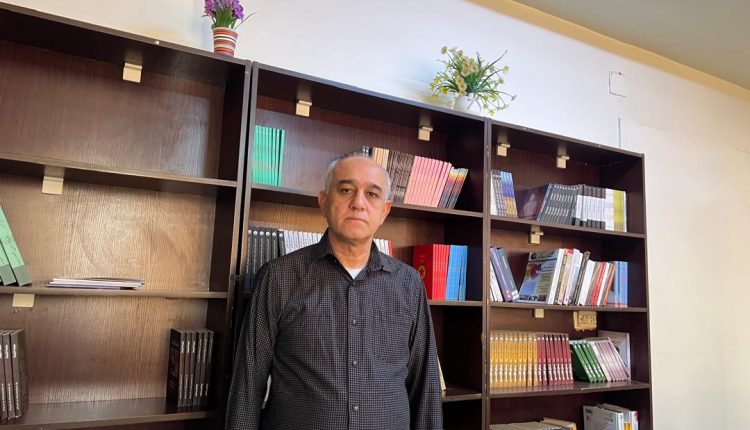الحلّ الديمقراطي لقضايا الشرق الأوسط: قراءة في فلسفة الحداثة الديمقراطيةالملخص :تتناول هذه المقالة مفهوم “الحلّ الديمقراطي” لقضايا الشرق الأوسط، بوصفه مشروعاً فكرياً وسياسياً بديلاً للأنماط القومية والدولتية التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار والتنمية. تنطلق الدراسة من تحليل الجذور التاريخية للأزمة الشرق أوسطية، مروراً بفشل الدولة القومية والحداثة الرأسمالية، وصولاً إلى طرح نموذج “الحداثة الديمقراطية” كما قدمه المفكر عبد الله أوجلان، القائم على مبدأ الأمة الديمقراطية، والإدارة الذاتية، واتحاد الأمم الديمقراطية. وتخلص المقالة إلى أن تجاوز أزمات المنطقة يتطلب إعادة بناء العلاقات المجتمعية والسياسية على أسسٍ تشاركية تعددية تحترم التنوع الثقافي والهوياتي لشعوبها.
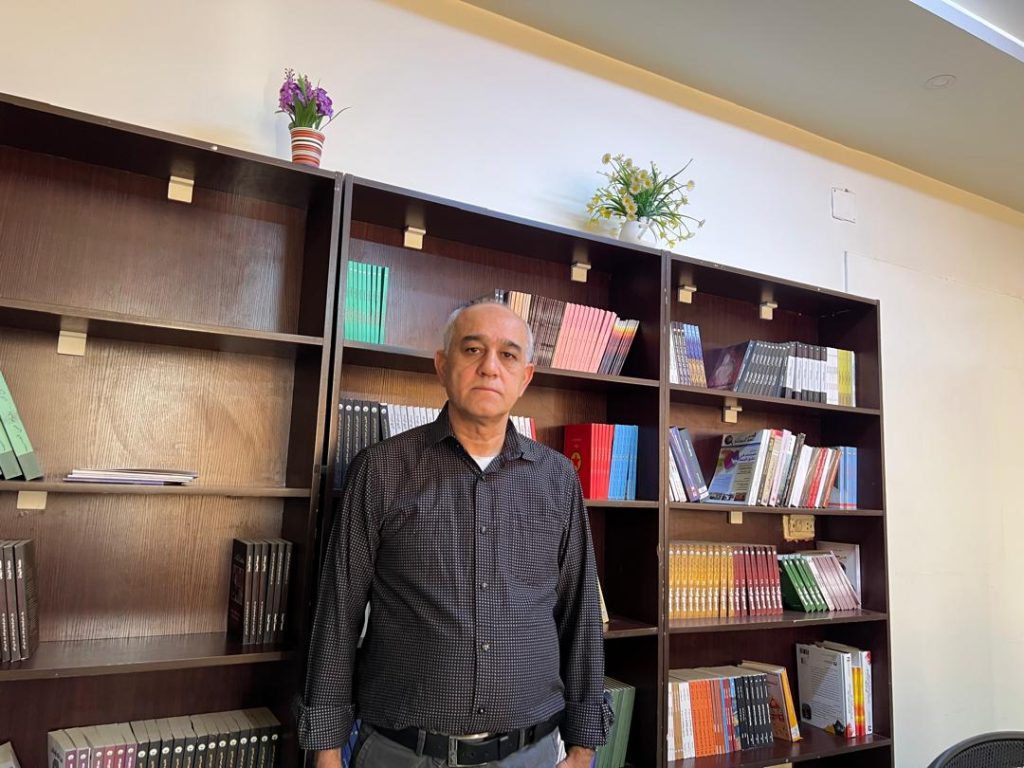
المقدمة:
يشكّل الشرق الأوسط نموذجاً فريداً للتاريخ الحيّ للصراع بين السلطة والمجتمع، بين المركزية والتعددية، وبين الاستبداد والحرية. فمنذ فجر الحضارات، كانت هذه المنطقة مسرحاً لتجارب إنسانية عظيمة من جهة، ولأزماتٍ متواصلة من جهة أخرى. فالمجتمعات التي أبدعت أولى أشكال التنظيم الاجتماعي في التاريخ، هي ذاتها التي شهدت نشوء أول أنماط الهيمنة الطبقية والدولتية.
لقد أنتجت هذه التحولات التاريخية منظومة من التناقضات البنيوية التي ما زالت تتحكم بمسار المنطقة حتى اليوم. ومن هنا تأتي أهمية البحث في الحلّ الديمقراطي باعتباره بديلاً فكرياً وسياسياً يعيد تعريف علاقة المجتمع بالدولة والسلطة.
أولاً: الجذور التاريخية للأزمة:
ترتبط الأزمة الشرق أوسطية ببنيةٍ تاريخية معقدة تعود إلى التحول من المجتمع الأمومي إلى المجتمع الأبوي السلطوي. ففي المجتمعات الأولى، كانت العلاقات تقوم على المساواة والتشاركية، إلا أن بروز العائلة الحاكمة والنظام الأبوي أدّى إلى تأسيس نموذجٍ أولي للسلطة والدولة، حيث أصبحت السيطرة والقوة معياراً للعلاقات الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، أسهمت الدينوية – أي تحويل الإيمان إلى أداةٍ سياسية – في تكريس الانقسامات بين المكونات الاجتماعية، ما أعاق تطور الإيمان الحرّ والمجتمع الديمقراطي. وجاءت الدولة القومية في القرن العشرين لتعمّق هذا التناقض، إذ فُرضت على مجتمعاتٍ متعددة الثقافات والهويات، فنتج عنها مزيد من التفكك والصراع.
ثانياً: إفلاس الدولة القومية
منذ انهيار السلطنة العثمانية، سعت القوى الاستعمارية إلى فرض نموذج الدولة القومية كصيغة تنظيمية للمنطقة. غير أن هذا النموذج فشل في استيعاب التعدد البنيوي لمجتمعات الشرق الأوسط. فبدلاً من أن تكون الدولة أداةً للتنمية، تحولت إلى جهازٍ قمعيٍّ يحتكر الهوية والثقافة والسيادة.
تجلّى هذا الفشل في سلسلة من الأزمات المزمنة: الحروب الداخلية، النزاعات الطائفية، والاقتصادات الريعية التابعة للغرب. كما استخدمت الأنظمة القومية الدين والقومية كأدواتٍ أيديولوجية لإدامة سلطتها، فظهرت أنماط من “الإسلام السياسي الفاشي” و”القومية الشمولية” التي عمّقت الانقسامات بدلاً من حلها.
ثالثاً: انهيار النماذج السلطوية
لقد أثبتت العقود الأخيرة أنّ النموذج الدولتي القائم على المركزية القومية وصل إلى نهايته التاريخية. فقد انهارت الاشتراكية الدولتية في الاتحاد السوفيتي، وفشلت المشاريع الإسلاموية في إيران وغزة، وتآكلت الأيديولوجية الكمالية في تركيا. كما دخلت أغلب دول المنطقة في أزماتٍ بنيوية حادة، تجسدت في تفكك المجتمعات، وتراجع الشرعية السياسية، وتآكل الثقة بين الدولة والمواطن.
هذه التحولات تؤكد أن الحلّ لا يمكن أن يأتي من داخل النموذج القومي ذاته، بل من تجاوزه نحو منظومةٍ فكرية جديدة تُعيد الاعتبار للمجتمع كمركزٍ للحياة السياسية والاجتماعية.
رابعاً: المجتمع الحيّ ومقاومة السلطة
رغم القمع المتواصل، حافظت مجتمعات الشرق الأوسط على حيويتها وقدرتها على المقاومة. فالعشائر، والقبائل، والمذاهب، والطرق الصوفية، لم تكن مجرد بُنى تقليدية، بل مكونات اجتماعية نشطة وفّرت للمجتمعات آليات بقاءٍ ذاتية في مواجهة السلطة الدولتية.
وفي هذا الإطار، يشكّل الشعب الكردي مثالاً بارزاً. فبعد تجارب متكررة لبناء دولة قومية على النمط الاشتراكي، أدركت الحركة الكردية أنّ الحرية لا تتحقق عبر تكرار نموذج الدولة القومية، بل عبر تجاوزه نحو بناء مجتمعٍ ديمقراطي تشاركي.
خامساً: الحداثة الديمقراطية كنموذج بديل
يقدّم عبد الله أوجلان مفهوم الحداثة الديمقراطية كإطارٍ فلسفي وسياسي بديل للحداثة الرأسمالية والدولة القومية.
تقوم هذه الحداثة على ثلاثة محاور رئيسية:
1. الأمّة الديمقراطية: نموذج اجتماعي مفتوح يقوم على التعدد والتكامل بدل الإقصاء والتجانس.
2. الاقتصاد الكومينالي: اقتصاد اجتماعي تشاركي يعتمد على التعاون والكوبراتيفات، ويجعل الثروات ملكاً للمجتمع لا للدولة.
3. الكونفدرالية الديمقراطية: صيغة سياسية لامركزية تربط المجتمعات ضمن شبكات من التعاون الذاتي، دون الحاجة إلى دولة قومية مركزية.
بهذا المعنى، لا تسعى الحداثة الديمقراطية إلى تدمير الدولة، بل إلى تجاوزها أخلاقياً وسياسياً لصالح نموذجٍ مجتمعي أكثر إنسانية وتعددية.
سادساً: كردستان كنموذج للتكامل الإقليمي
من هذا المنظور، تُطرح قضية وحدة كردستان ليس باعتبارها مشروع انفصالٍ سياسي، بل مشروع تكامل ديمقراطي. فالوحدة الكردية تتحقق من خلال مؤتمرات وبرامج تأسيسية منفصلة في كلٍّ من سوريا والعراق وتركيا وإيران، ضمن رؤية مشتركة تعرف بـ اتحاد كومونات كردستان الديمقراطية.
يهدف هذا النموذج إلى جعل كردستان فضاءً للتعاون بين الشعوب، وجسراً للتواصل بين الدول الأربع، بدلاً من أن تكون نقطة توتر وصراع.
سابعاً: نحو اتحاد الأمم الديمقراطية
يمتد أفق الحداثة الديمقراطية ليشمل المنطقة بأكملها من خلال فكرة اتحاد الأمم الديمقراطية في الشرق الأوسط، كبديل عن التحالفات القومية الضيقة.
يقوم هذا الاتحاد على مبدأ الإدارة الذاتية والتعاون الإقليمي، ويُنظر إليه كبداية لإعادة تشكيل النظام العالمي على أسسٍ ديمقراطية تشاركية، يمكن أن تتطور لاحقاً إلى اتحاد عالمي للأمم الديمقراطية.
الخاتمة:
تؤكد فلسفة الحلّ الديمقراطي أنّ أزمات الشرق الأوسط ليست قدراً تاريخياً، بل نتيجة منظومة فكرية مغلقة قامت على الاستبداد ونفي التعدد. والحلّ لا يكمن في إعادة إنتاج هذه المنظومة، بل في استبدالها بمشروعٍ إنساني جديد يقوم على الحرية، والمساواة، والتكامل.
إنّ الحداثة الديمقراطية تقدّم أفقاً عملياً وحضارياً لتجاوز المأزق التاريخي للمنطقة. فهي لا تسعى إلى إقامة دولة جديدة، بل إلى بناء مجتمعٍ جديد، يتأسس على الإرادة الحرة، ويعيد التوازن بين الفرد والمجتمع، وبين الإنسان والطبيعة، في إطارٍ من التعايش والتكامل بين الشعوب.
وبذلك يمكن القول إنّ مستقبل الشرق الأوسط لن يُبنى من خلال الخرائط السياسية، بل من خلال إعادة إحياء الإنسان الديمقراطي القادر على تحويل التنوع إلى قوةٍ خلاقة، وصياغة حياةٍ جديدة تتجاوز منطق السلطة نحو منطق الحرية.
بقلم:فرزندا منذر